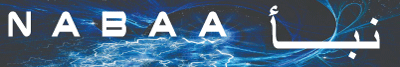على الرغم من العراقيل التي يجهد على وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومعه اليمين المتطرف، إلا أن الترجيحات حيال نتائج مفاوضات شرم الشيخ تنحو باتجاه التفاؤل. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس ضغوطا هائلة، وهو المستعجل على اقتناص “فوز” تاريخي، سيسمح له وفق حساباته على الحصول على جائزة نوبل للسلام. ولذلك فهو يضغط بقوة لتحقيق قرار إنهاء الحرب سريعا، وتحديدا قبل نهاية الأسبوع الجاري. لذلك اندفع الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في خطوة إستفزازية باتجاه باحات المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي طلبا للمواجهة والفوضى بهدف نسف المفاوضات. لكن ضغوط ترامب تبدو أكبر وأكثر تأثيرا.
وتأكيدا على جديته القصوى، أرسل ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الى شرم الشيخ في إشارة قوية بأنه يريد نهاية “سعيدة” وسريعة. وهو كان أعلن عن اجتماعه بهما قبل انطلاقهما الى مصر. وانضم الموفدان الأميركيان الى رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات التركية وأيضا الوزير الإسرائيلي الأقرب الى نتنياهو رون ديرمير. صحيح أن هنالك خلافات كثيرة تحيط بكيفية تفسير خطة العشرين نقطة، لكن ضغوط ترامب تقول بأنه لا يجب أن يشكل ذلك عائقا أمام الموافقة على خطته. وفي الوقت الذي أرسلت فيه إيران إشارات قوية بأنها لن تعمد الى العرقلة، مرة بشكل مباشر ومرة أخرى عبر حليفها الأهم أي حزب الله بعد أن كان موقفها سلبيا قبل أيام معدودة فقط، فإن نتنياهو بدأ يشعر بأنه يتجه لخسارة معركته عبر الخضوع لقرار وقف الحرب. فبخلاف ادعاءات الربح، فإن اليمين الإسرائيلي بات يدرك بوضوح بأن مشروعه باستمرار الحرب حتى تهجير غزة من سكانها بات مهددا.
وفي قراءة تاريخية سريعة، لم يعد سرا أن الحكومات الإسرائيلية، خصوصا اليمينية منها، شجعت ولادة ونمو حركة حماس. وكانت تهدف من وراء ذلك خلق منافس ديني بوجه ياسر عرفات ومن أتى بعده، على أن يشكل ذلك عائقا أمام تثبيت ركائز السلطة الفلسطينية. فالهدف هو نسف فكرة مشروع “الدولتين” لصالح قيام الدولة اليهودية. ولذلك كانت الحكومات الإسرائيلية تتسامح مع التمويل الشهري الذي كانت تتلقاه حركة حماس منذ إحكام قبضتها على قطاع غزة، وتغض النظر في الوقت نفسه عن تهريب السلاح إليها عبر معابر سيناء لاعتقادها بأنها لن تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا على أمن إسرائيل. وحين حصلت مواجهات عسكرية في الأعوام 2008, 2009, 2012, 2014 و2021 بقيت العمليات العسكرية تحت سقف منخفض ومدروس، وحملت عناوين يكتنفها الغموض، مثل “استعادة قوة الردع” و”تغيير قواعد اللعبة”. ولا شك بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت تراقب حركة حماس وتتابعها، لكنها أخطأت في تحليل التهديد الذي كان ينمو ويكبر داخل أنفاق غزة الهائلة. وهي ليست المرة الأولى. فقبل ذلك أخطأت الإستخبارات الإسرائيلية في قراءة وتحليل إستعدادات سوريا ومصر لحرب العام 1973 رغم امتلاكها معلومات كافية، ما أدى الى توجيه ضربة قوية لإسرائيل في حرب مباغتة. وأطاحت تحقيقات ما بعد الحرب بغولدا مائير والطاقمين السياسي والعسكري. وهو ما يشكل سببا إضافيا لنتنياهو لعدم وقف الحرب وفتح باب المحاسبة الداخلية.
في غزة، لم تدرك الأجهزة الإسرائيلية المعنية بأن حركة حماس المدعومة بقوة من إيران، تعمل لتحقيق هدف مختلف تماما عما تأمله إسرائيل، ألا وهو بناء ذراع عسكرية قوية جدا. ومع اطلاق عمليتها “طوفان الأقصى” فوجئت لا بل صدمت إسرائيل بالقوة العسكرية لحماس. كما أن حركة حماس نفسها فوجئت بالضعف العسكري للقوات الإسرائيلية المنتشرة حول غزة. ومنذ ذلك الحين، أي منذ عامين بالتمام والكمال اعتمد نتنياهو، المذهول من النتائج الكارثية، وبالتفاهم مع واشنطن إستراتيجية جديدة ترتكز على تدمير القوة العسكرية التي بنتها إيران في غزة والمنطقة، والشروع في إحياء مشروع تفتيت المنطقة وفق دويلات طائفية ومذهبية وعرقية، إضافة الى هدف إسرائيلي ضمني يرتكز على تصفية الوجود الفلسطيني نهائيا في فلسطين.
وعملية “طوفان الأقصى” والتي تضمنت هجوما محكما ومنسقا على جبهات متعددة أظهرت إسرائيل بأنها فقدت ميزة الردع التي لطالما تغنت بها، وبنت مجدها الإقليمي عليها. ولا بد أن نتنياهو يعيش هذا الهاجس، وهو المدرك بأن وقف الحرب سيعني تشكيل لجنة تحقيق رسمية وفتح قاعات المحاكمة. ولا بد من الملاحظة بأن نتنياهو لم يعلن أبدا منذ بدء الحرب بأنه يتحمل ولو جزءا من المسؤولية، بخلاف بعض كبار المسؤولين العسكريين مثل الرئيس السابق لأركان الجيش هرتسي هاليفي. لا بل أن نتنياهو يرفض تحميله أي مسؤولية، ويلقيها على عاتق المستوى الأمني. كما أنه يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويدعو بدلا من ذلك الى تشكيل لجنة حكومية تمنحه القدرة على التأثير والتحكم بقرارات أعضائها.
والأسوأ بالنسبة لنتنياهو تلك العزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل لأول مرة منذ إنشاء هذا الكيان. والتعاطف الدولي كان يشكل إحدى أوراق القوة التي كان يردها نتنياهو الى سياسته. فمن مشهد التظاهرات المنددة التي تجتاح العواصم العالمية والتي كانت تعتبر حليفة لإسرائيل، وصولا الى قاعة الأمم المتحدة شبه الفارغة عند إلقاء نتنياهو لكلمته، كل ذلك سيشكل ما يشبه المقصلة لرأس نتنياهو السياسي.
وفي استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، ظهر انخفاضا حادا بالثقة بالحكومة الإسرائيلية، والذي وصل الى 61% مقابل 38% لصالحها. وحول تحسن الوضع الأمني منذ 7 أوكتوبر أعطى 43% جوابا إيجابيا مقابل 42,5% قالوا أنه ازداد تدهورا. أما 51% فأعربوا عن خشيتهم من احتمال وقوع حدث مشابه ليوم 7 أوكتوبر في المستقبل. واللافت أن 53,5% فقط إعتبروا أن الجيش مستعد بدرجة عالية لحماية بلدات الشمال. وهذه الأرقام تدفع نتنياهو للإستمرار في مغامرته الحربية لا العكس.
وما بين فشل مشروع اليمين بتهجير كل الفلسطينيين عن أرضهم، والمخاطر الشخصية والسياسية التي باتت تهدد مستقبل نتنياهو، أمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن تنسف حركة حماس مبادرة ترامب. لكن نتنياهو الذي يدرك بأن ترامب الذي يعاني في الداخل الأميركي، سينفجر غضبا بوجه من سيقف أمام طموحه بالفوز بجائزة نوبل للسلام. وغضب شخص مثل ترامب سيكون عاصفا من دون أدنى شك. وطالما أن حركة بن غفير الإستفزازية باتجاه الأماكن الإسلامية المقدسة لم تؤد الى الردود المطلوبة، بات على الحكومة الإسرائيلية اليمينية التفكير بحلول أخرى لإبقاء البلاد في حال الحرب، والمقصود هنا جبهات إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية.
بالنسبة لإيران، فإن القرار يبقى أميركيا في الدرجة الأولى أكثر منه إسرائيليا، وهو ما أثبتته الحرب الأخيرة. وطالما أن إدارة ترامب تعمل على تطويع إيران من خلال العقوبات، الى جانب أسلوب التفاوض، فإن استعادة الحرب عليها لا يبدو ميسرا في هذه الفترة على الأقل. فوفق الحسابات الأميركية، فإن أي حرب جديدة على إيران قد تؤدي الى انهيار النظام القائم بسبب مشاكله الداخلية الكبيرة، وهو ما لا تريده واشنطن الآن. أضف الى ذلك أن خطر السلاح النووي لم يععد قائما في المرحلة الراهنة.
أما بالنسبة للحوثيين في اليمن، فإن الجبهة بعيدة، والحوثيين قادرون على تحمل أكلاف المواجهات مهما كانت كبيرة. أضف الى ذلك أن عمليات القصف على مناطقهم لا ينتج وقعا كبيرا على الشارع الإسرائيلي. وبالتالي تبقى جبهتين: الضفة الغربية وحزب الله.
وجاء إعلان إسرائيل عن اكتشاف شحنة أسلحة كبيرة إيرانية الى الضفة لتطرح الأسئلة حول ما يعمل نتنياهو للتحضير له. وهذا ما دفع بملك الأردن القلق من تداعيات هذا المشروع على استقرار الأردن الداخلي، الى التواصل بسرعة مع واشنطن محذرا من خطورة هذا المشروع على استقرار بلده، وهو ما سيشرع الأبواب أمام إيران للعودة بقوة الى المنطقة من خلال الفوضى التي ستنتشر، بعدما جرى إخراجها منها بالقوة. وربط الملك عبدالله بين ما يخطط له نتنياهو وبين الآمال المعقودة على نتائج المفاوضات الدائرة في شرم الشيخ.
تبقى الساحة اللبنانية، والتي قد تبدو لنتنياهو أقل تعقيدا للذهاب في مغامرة جديدة. فاستهداف حزب الله يحظى “بجاذبية” إسرائيلية داخلية، وفي الوقت نفسه قد لا يلقى معارضة دولية كما هو حاصل الآن على المستوى الفلسطيني. لكن ثمة عوائق بدأت تظهر في الأفق. فإدارة ترامب باتت تستمع أكثر لتقييمات الديبلوماسيين في وزارة الخارجية والخبراء في سياسة الشرق الأوسط. ويميل هؤلاء الى تشديد الضغط على حزب الله وتنفيذ رقابة جوية قوية عليه ولكن من دون التورط في حرب واسعة جديدة. فوفق هؤلاء فإن حرب الإستنزاف الجوية تؤدي غرضها. ولكن يجب التنبه الى أن إدارة ترامب لن تعارض نتنياهو في حال قرر رفع مستوى الحماوة عبر توجيه ضربة واسعة على حزب الله.
كذلك فإن رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا لاوون الرابع عشر قرر أن يكون لبنان أول محطة خارجية له بعد انتخابه. صحيح أنه سيزور قبل ذلك تركيا، لكن هذه الزيارة تأتي في إطار الإحتفال بالذكرى التاريخية لأول مجمع في تاريخ الكنيسة في المكان نفسه الذي عقد فيه، أي أن الزيارة يمكن إدراجها في الإطار الديني، وهي لا تأتي في السياق نفسه لزيارة لبنان. ومن الواضح أن زيارته للبنان والتي لم يستطع سلفه تحقيقها لأسباب عدة، تأتي في إطار دعمه للبنان وللمسيحيين فيه إزاء المخاطر الكبرى التي يتعرضون لها. وهي زيارة دعم للدولة اللبنانية ولرئيس الجمهورية وهو الرئيس المسيحي الوحيد بين الدول العربية ودول المنطقة التي يعصف بها التطرف الديني. وبعد زيارة البابا لاوون، يجري التحضير لزيارة أخرى سيقوم بها شيخ الأزهر الى لبنان، ومن المفترض أن تحصل قبل نهاية العام الحالي. واستطرادا، هل سيغامر نتنياهو بإشعال جبهة لبنان، ما سيؤدي الى إجهاض هاتين الزيارتين، في وقت ستتركز فيه الأضواء الإعلامية الدولية على لبنان ولكن من زاوية مختلفة تماما عن زاوية العنف والحرب؟
تاريخيا عودتنا إسرائيل بأنها لا تعري إهتماما كبيرا لاستحقاقات من هذا النوع. صحيح أن نتنياهو يعاني من عزلة دولية وهو لا يناسبه استمرار الوضع على هذا المنوال، لكنه في الوقت نفسه قلق الى أقصى حد من وضع رقبته السياسية تحت مقصلة الإدانة الداخلية وأحكام التاريخ. ما يعني أنه قد يجد نفسه ملزما بالإندفاع الى الأمام.