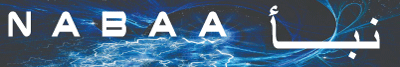ما من شك بأن الزيارة التي قام بها الوفد الأميركي الى لبنان كانت بالغة الأهمية والأكثر دقة من بين كل الزيارات التي سبقت منذ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام. فهي حملت رسائل سياسية وعسكرية واقتصادية، وهي أثارت الكثير من الجدل. البعض قرأ في الزيارة بأنها تهدف للقول بأنه لا يجب التراخي في تنفيذ مقررات مجلس الوزراء، وأنه من غير المسموح ترك حزب الله ينجح في سياسة “شراء الوقت” التي يعتمدها.
وقد أحاط بهذه الزيارة الكثير من اللغط، بدءا من التشكيلة “الدسمة” للوفد الأميركي والتي جمعت ما بين أعضاء في الإدارة وآخرين في المجلس التشريعي وهو ما يعتبر إستثنائيا في الزيارات الأميركية الى لبنان، ومرورا بالإستعراضات في شورارع ومطاعم بيروت تحت عدسات الأعلام، والإعلان المسبق عنها، ومن دون الحذر الأمني الذي يرافق عادة زيارات الوفود الأميركية، وانتهاء بالتعابير النابية والصادمة للموفد الرئاسي الأميركي توم براك والتي تشكل سقطة أخلاقية كبيرة على كافة المستويات، خصوصا وأنها لم تستلحق بإعتذار رسمي، ربما لعدم إيجاد تبرير منطقي لما تفوه به الموفد الرئاسي الأميركي. فالتشكيلة الأميركية تعزز الإنطباع بأن الملف اللبناني يحتل صدارة إهتمامات البيت الأبيض خلافا لما كان جرى ترويجه في السابق. لكن تصاريح مختلف أعضاء الوفد أظهرت بشكل لا لبس فيه تبني واشنطن لوجهة النظر الإسرائيلية لمسار الحلول المطروحة. وقد اقترن ذلك مع “الهمروجة” التي رافقت تحركات أعضاء الوفد في شوارع بيروت. فتداول الإعلام اللبناني مسبقا عن حفلات العشاء التي شارك فيها أعضاء الوفد كان يشكل سابقا خطيئة أمنية تؤدي فورا الى إلغاء المشاركة. وما حصل مع أعضاء الوفد الأميركي، لاسيما مع التسريحة المصورة في أحد صالونات بيروت، شكل سابقة أمنية لم تحصل منذ اندلاع الحرب في العام 1975، ولهذا معناه الكبير. ذلك أن أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم كان استبق وصول الوفد الأميركي بخطاب ناري أعرب فيه رفضه تسليم السلاح والذي هو بمرتبة الروح. وتلا ذلك الإعلان عن تجمع شعبي في الساحة المواجهة للسراي الحكومي رفضا لقرار سحب السلاح قبل العودة عنه بعد ست ساعات فقط. وقيل لاحقا بأن هدف الثنائي من الدعوة ومن ثم الرجوع عنها كان مقصودا ولتوجيه رسالة بأن خيار استعمال الشارع مطروح. لكن تحرك أعضاء الوفد بحرية في شوارع بيروت أظهر وجود رسالة أميركية مضادة تقول بأن بيروت لم تعد مكانا خطرا أو حتى معاديا للأميركيين، وأن واقع لبنان تغير فعلا، والمعادلة السابقة أضحت من الماضي. وليس تجول أعضاء الوفد بحرية هي الإشارة الأميركية الوحيدة في هذا الإطار. فالسفارة الأميركية في لبنان كانت أحجمت عن إقامة إحتفال الرابع من تموز السنوي من دون توضيح الأسباب. ولكن تردد يومها أن السبب يعود للإجراءات الأمنية. فالإحتفال يقام في منطقة مكشوفة “مارينا الضبية” ما يفرض التأقلم مع حال الحذر الأمني المتبعة في لبنان. لكن، وفي سابقة أخرى، عمدت السفارة للدعوة للإحتفال من جديد ولكن في أواسط شهر أيلول. وهو ما يعني أن حال الحذر الأمني لم تعد قائمة. ولكن المتعارف عليه أن الواقع الأمني في لبنان يخضع للقرار السياسي، وهنا يصبح السؤال حول المستجدات السياسية التي سمحت للأميركيين بهذه الحركة.
فلقد كان لافتا أن تتزامن زيارة الوفد الأميركي الى بيروت مع إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إستعداد بلاده لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني مع الأميركيين. وجاء ذلك بعد انعقاد أول اجتماع بين مسؤولين كبار من إيران والترويكا الأوروبية حول البرنامج النووي منذ انتهاء الحرب مع إيران. صحيح أن الإجتماع لم يشهد تقدما حقيقيا، لكنه في الوقت نفسه لم يكن فاشلا. ولكن هذه الحركة الإيرانية باجاه واشنطن خصوصا، تظهر بأن هامش المناورة أصبح ضيقا جدا، وأن الواقع بات يدفع لفتح الأبواب أمام التسويات والتفاهمات السياسية، لا الرهان على مواجهات عسكرية جديدة، خصوصا وسط تحريض إسرائيلي دائم بأن طهران لا توقف النار بل تعمد على إعادة تذخير أسلحتها. ويأتي ذلك في وقت يقوم فيه الجيش الأميركي بالتخفيف من تواجده في مختلف مناطق وساحات الشرق الأوسط إيذانا منه بأن الحروب انتهت على الأقل في الوقت الراهن.
وإيران التي تعمل على استخلاص دروس الحرب وإعادة ترميم قوتها وإصلاح الخلل الذي اعترى منظومة القيادة العسكرية تدرك أنه عليها إعادة خلط أوراقها الأمنية والعسكرية من جديد ولو من خلال أدوار جديدة للأسماء المألوفة والأدوات التنظيمية المتوفرة. ومن هنا إعادة علي لاريجاني الى موقع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي ولكن مع إضافة جديدة وهي كممثل للمرشد الأعلى. وليس تفصيلا ما صرح به وزير الدفاع الإيراني بأن بلاده بالغت أحيانا قبل اندلاع الحرب في تقاريرها وعروضها الإعلامية حول قدراتها العسكرية، وذلك خلال مقابلة له مع التلفزيون الإيراني. وفي ورشتها الداخلية القائمة نفذت طهران تغييرات عسكرية وأمنية جذرية كمثل استحداث مجلس دفاع جديد وإعادة تدوير وجوه سياسية قديمة في إطار خلط أوراقها الأمنية مجددا. وهي عملت على استحضار دروس وإجراءات مرحلة ما بعد الحرب مع العراق عام 1988 حين لجأت لتفعيل هياكل مصغرة ولكن عالية التركيز لتجاوز بطء البيروقراطية وضمان سرعة اتخاذ القرارات. لكن طبيعة التحديات تختلف عن الحرب التي جرت مع العراق. فهنالك الحرب الإستخباراتية الهجينة، والهجمات السيبرانية، والإستهداف الدقيق لقيادات الصف الأول، إضافة الى تحريض داخلي متنامي يرتكز على احتجاجات شبابية وسط “ضجر” من الطبقة الحالية. وفي استطلاع أجراه معهد GAMAAN لاستطلاعات الرأي ومقره هولندا، والذي شمل حوالي 20 ألف إيراني، أبدى 70% منهم معارضتهم للسلطة القائمة، والأخطر أن 40% إعتبروا أن سقوط النظام القائم سيكون شرطا أساسيا للتغيير، وأن 89% يؤيدون النظام الديمقراطي كبديل للنظام الديني. وتسجل الأرقام المعارضة، النسبة الأعلى لدى شريحة الشباب وسكان المدن والذين يتمتعون بمستوى تعليمي عالي نسبيا. وهذه الشرائح تعتبر الأكثر ديناميكية، وهنا مكمن الخطورة. وهذا يعني أن النظام القائم في طهران بحاجة ماسة لفترة طويلة من الهدوء والإنكفاء لإعادة بناء دينامية جديدة وثوب سياسي حديث يسمح له بتثبيت أقدامهه للعقود القادمة. ولا شك أن واشنطن التي تدرك ذلك والتي تفضل عدم استهداف النظام الديني القائم، تدرك بأن الهوامش التي كانت قائمة في الشرق الأوسط ضاقت كثيرا، وهو ما يسمح بتركيز معادلات جديدة متجانسة مع خارطة النفوذ السياسي الجديد.
وفي موازاة ذلك باشرت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي “سنتكوم” في تطبيق استراتيجية انتشار عسكري جديدة ترتكز على التعاون ورفع مستوى التنسيق مع جيوش وقوى المنطقة، وفي المقابل تخفيف الإعتماد على الأعداد الكبيرة للجيش الأاميركي، وعبر اعتماد سياسة الحشد السريع التي تقوم على نقل القوات الى مناطق النزاع عند الضرورة وبالسرعة المطلوبة، عن طريق الجو وعبر الأساطيل المنتشرة حول العالم. ومن هنا فإن تقديرات البعض حول تخفيف عديد القوات الأميركية في المنطقة ووضعه في خانة تراجع اهتمام واشنطن بشؤون الشرق الأوسط إنما هو اعتقاد خاطىء بالكامل.
وانطلاقا من هذه الإستراتيجية العسكرية الجديدة حاولت تركيا نيل تفويض لتسليح وتدريب الجديد وفق العقيدة الغربية، ما يؤمن التوازن مع روسسيا ويمنعها من السيطرة على الجيش، وهي التي تملك رصيدا تاريخيا تسليحا وتدريبا. وكذلك للوقوف بوجه محاولات إيران للنفاذ الى الساحة السورية. وبالفعل باشرت دمشق حملة تطويع لصالح الجيش السوري بعد التوقيع على تعاون عسكري مع تركيا. لكن إسرائيل أبدت معارضتها لنفوذ تركي قوي داخل التركيبة العسكرية السورية، ووجهت رسائل بهذا الصدد بعضها من خلال قصف جوي لبعض المواقع العسكرية السورية. لكن دمشق قلقة أيضا من التشجيع الإسرائيلي لانفصال الدروز والأكراد عن سلطة دمشق. وهو ما جعل واشنطن تقترح التوقيع على معاهدة دفاعية مع دمشق ترتكز على تعاون عسكري وثيق مع الجيش السوري. ولكن الأهم اعتراف الشرع بوجود مفاوضات بين سوريا وإسرائيل، وأنها قطعت شوطا متقدما بشأن اتفاق أمني بينهما، وفق خط الهدنة عام 1974.
وإذا افترضنا تشابه المطالب الإسرائيلية ما بين سوريا ولبنان فأنه من البديهي الإستنتاج بأن إسرائيل قد تقبل باستعادة اتفاقية الهدنة معدلة، ولكن بعد مفاوضات مباشرة، وليس الذهاب للتطبيع كما يشاع على نطاق واسع في الإعلام. لكن اللافت ما قاله وزير الأمن الإسرائيلي بأن إسرائيل ستبقى في الجزء المحتل حديثا من جبل الشيخ، إضافة الى المنطقة الأمنية بهدف حماية الجولان والجليل حسب إدعائه. وهو ما يعني أن إسرائيل لن تنسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان للأسباب عينها. لا بل أنها لن تقبل أبدا بإعادة إعمار ما صنفته كشريط أمني لها.
ووفق ما تقدم فإن وقوف واشنطن عبر وفدها الى بيروت الى جانب وجهة النظر الإسرائيلية له أسباب أبعد مما يجري تبريره إعلاميا. هو واقع جديد يجري العمل على ترسيخه أسوة بما هو حاصل مع الجنوب السوري. ولكن، هل من الممكن إجهاض هذا الواقع، خصوصا وأن إسرائيل بدأت تطبق نظرية مرحلة مقابل مرحلة بدل نظرية الخطوة مقابل الخطوة.
يقولون بأن السياسة تأتي انعكاسا للتوازنات الميدانية. فوفق هذه النظرية كانت الكلمة الأقوى طوال العقدين الماضيين في المنطقة لإيران. أما اليوم فالتوازنات اختلفت. فمثلا لم تتمكن إيران من تمرير مشروع القانون الجديد للحشد الشعبي في العراق، والذي يشكل أهمية فائقة لطهران. فلقد جرى شطب هذا البند من جدول أعمال جلسات مجلس النواب العراقي، مع العلم أنه كان يمكن إقراره بأغلبية مريحة تملكها إيران. لكن تبعات الرفض الأميركي له جعلت القوى المتحالفة مع إيران تعمل على سحبه. وبالتالي يمكن الإستنتاج بأن “حرية” حركة حزب الله في لبنان لا تبدو متوفرة في ظل الظروف الصعبة لإيران. وهو ما جعل الوفد الأميركي يشعر بحرية الحركة والتي إفتقدتها واشنطن دائما في السابق، وهو الذي يؤدي الى إدراج المواقف العالية السقف في إطار تسجيل نقاط إعلامية وليس كتحضير لترجمة فعلية على أرض الواقع، في وقت تتحضر فيه واشنطن لفتح أبواب الدعم لصالح الجيش اللبناني، وتزويده بأسلحة جديدة نوعية، كمثل مروحيات قتالية هجومية.