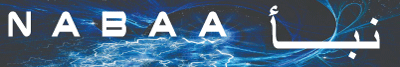في الوقت الذي كانت فيه أنظار العالم تتركز على دمشق إثر سقوط نظام بشار الأسد والذي واكبته مظاهر البهجة والفرح لدى السوريين كان رئيس الحكومة الإسرائيلية منشغلا بما هو أهم. فهو أمر الجيش الإسرائيلي بالتقدم والسيطرة على المناطق العازلة وعلى جبل الشيخ، فيما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تعمل على تدمير مواقع الأسلحة الكيمائية ومخازن الصواريخ البالستية والبعيدة المدى، أو بمعنى أوضح نزع “الأظافر” العسكرية قبل أن يستفيق السوريون من سكرة سقوط نظام الأسد.
ولا شك أن السقوط الكبير لنظام الأسد شكل صدمة كبيرة وطرح العديد من التساؤلات حول “أسرار” هذا الإنهيار السريع. فوحدات الجيش السوري استنكفت عن القتال، حتى تلك التي كانت معروفة بولائها الشديد للنظام وبقدرتها القتالية كمثل الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة تحت إمرة ماهر الأسد. كما أن القاعدة الشعبية المفترض أنها حاضنة للنظام والمقصود هنا الطائفة العلوية لم تتصدى ولم تقاوم المجموعات المسلحة وذلك بخلاف سلوكها الشرس عند انطلاق الثورة في العام 2011. وهذا ما طرح العديد من علامات التعجب حول الهوة الكبيرة التي كانت قائمة بين التركيبة الحاكمة من فوق وبين البيئة المحسوبة على النظام القائم. ولا شك أن الأوضاع الإقتصادية المزرية وسط أحاديث عن الفساد أدى الى تفكك الطبقة التي من المفترض أن تشكل درع الحماية للسلطة القائمة، وبالتالي إحجامها عن تلبية نداءات المساندة والدعم.
ولكن ثمة نقطة أخرى لا تقل أهمية ساهمت بجعل النظام يقف وحيدا. فالمجموعات المهاجمة كان عمودها الفقري متطرفو جبهة النصرة. وما بين “النصرة” والبيئة المصنفة موالية مواجهات وبرك دماء كثيرة، وهو ما يفترض أن يبقي حال العداء قائما حتى ولو بدلت “النصرة” تسميتها بهيئة تحرير الشام، وحتى لو أعلن أبو محمد الجولاني خروجه من تحت عباءة القاعدة ودخوله الى واقع أكثر براغماتية عبر العودة الى إسمه الأصلي أحمد الشرع. ذلك أن أتباعه ومقاتليه بقيوا على الهوية نفسها وهو ما عكسه مظهرهم على الأقل. وقد يكون الإنضباط الذي مارسه هؤلاء بدءا من حلب خفف من منسوب الرفض الذي كان قائما. لكن هنالك سبب أكثر وجاهة أدى الى تقليص المسافة بين الشارع السوري والمجموعات المهاجمة وهو نفورها من المجموعات المحسوبة على إيران. وهذا النفور كان واضحا ليس فقط على المستوى السني ولكن حتى على مستوى الشارع العلوي.
ومع انطلاق العملية العسكرية في 27 من الشهر الماضي أي غداة الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، وبعد تخطيط طويل تولته أنقرة ورعته واشنطن ووضعت في أجوائه موسكو وتابعت تفاصيله الدقيقة تل أبيب، إنطلقت الحملة العسكرية وهي تحمل هدفا واضحا بإنهاء النفوذ الإيراني في سوريا. ولذلك شكل إغتيال الجنرال الإيراني لحظة الإنطلاق وليتكرس الهدف بوضوح مع الدخول الى مبنى القنصلية الإيرانية في حلب. وجاءت خاتمة الحماة العسكرية بالدخول الى دار السفارة الإيرانية في دمشق بعد تمزيق صورة قاسم سليماني مهندس “محور المقاومة” ومبدأ وحدة الساحات ومعه صورة السيد حسن نصرالله والذي تولى فعليا طوال المرحلة الماضية مهمة قائد المحور.
لكن لإسقاط نظام الأسد أهداف أخرى لا تقل أهمية. فالنظام الذي حرصت إسرائيل في السابق على منع الإطاحة به وجدت الآن أن الوقت حان للذهاب الى طريق آخر يضمن الوصول الى “تغيير وجه المنطقة”. فالمنطقة الممتدة من حلب الى إدلب وحماه وحمص أضحت منطقة نفوذ تركية. والمنطقة المقابلة شرقا أضحت تحت نفوذ الأكراد. كما أن الشريط الساحلي حيث القواعد العسكرية الروسية أضحى تحت إشراف موسكو. أما المنطقة الجنوبية فهي تنقسم ما بين احتلال عسكري إسرائيلي مباشر وما بين مناطق أخرى مثل السويدا ودرعا تخضع للنفوذ الإسرائيلي. أما العاصمة دمشق فستشكل نقطة التقاء لهذا الخليط المتشعب. ولذلك من المفترض أن تحتضن دمشق ولادة هيئة حكم انتقالية تتولى كتابة دستور جديد وتتولى بعدها تنظيم انتخابات شعبية، ولكن مع احترام مبدأ التقاسم الذي شهدته الساحة السورية.
ولا حاجة للقول بأن إيران كانت أكبر الخاسرين وخرجت من دون أي تعويض للإستثمارات الهائلة التي صرفتها في سوريا. لكن الصورة ليست وردية عند الجانب “المنتصر”. فالعناصر المتطرفة والتي قاتلت تحت راية الجولاني قد لا تتأخر في التأكيد على حضورها. صحيح أن أحمد الشرع والدول المساندة له ستعمل على تطهير صفوف المقاتلين، لكن هذا لن يمنع من حصول مواجهات أمنية متنقلة. وكذلك فإن المواجهات قد تحصل بين هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى شاركت في القتال وتطمح بحصة من قالب الحلوى. أما المواجهة الداهمة والأهم فستكون بين المجموعات المحسوبة على تركيا والأكراد الذين سيطروا على منطقة شاسعة ويتمتعون بالدعم الأميركي. وقبل سقوطه سلم الأسد بعض مواقعه شرق سوريا الى قسد إضافة الى مطار مع طائرات حربية هي الأفضل لدى سلاح الجو السوري.
وإيران التي تلقت الضربة الثالثة في المنطقة بعد غزة ولبنان ستجد من دون شك أن استعادة لعبتها التي تتقنها بالرهان على الوقت لإعادة بناء ما تهدم “على السكت” ومن دون إحداث ضوضاء في لبنان، إنما أصبح صعبا جدا بعد خروجها من سوريا. لا بل فإن المنطق يقول بوجوب التنبه لموقعها في العراق حيث يعتقد أنه سيكون المحطة الرابعة. ذلك أنه قبل سقوط دمشق كان حزب الله قد باشر برسم استراتيجية “العودة” وهو ما فهم من كلام أمينه العام الشيخ نعيم قاسم عن أن الإتفاق يتحدث فقط عن جنوب الليطاني. وباشرت طهران في إعادة ضخ بعض الأموال النقدية في شرايين حزب الله إضافة الى البحث في كيفية إعادة ترميم البنية العسكرية للحزب، إن من خلال تأمين ممرات لتهريب الأسلحة وتخزينها أو من خلال تصنيع بعض الأسلحة طالما أن تجربة غزة في هذا المضمار كانت مشجعة. ومن هنا يفهم لماذا سارع حزب الله الى إرسال ألفي مقاتل الى القصير حيث الممر البري الى لبنان والخاضع لحزب الله، وحيث يقال أن هنالك مخازن صواريخ ومصانع لها. وتوقع كثيرون أن يدافع حزب الله عن هذه المنطقة. لكن سقوط النظام بالكامل قد يكون عدل هذا التوجه خصوصا وأن كلفة هذه المعركة ستكون كبيرة ومن دون تحقيق الأهداف المطلوبة بسبب التبدل الذي حصل في دمشق.
وهذا الأسبوع يبدأ توافد الضباط الأميركيون من ذوي الإختصاصات الى السفارة الأميركية لمعاونة أعمال لجنة المراقبة الخماسية. مع الإشارة هنا الى أن التجربة الصعبة لقرار وقف النار الهش في جنوب لبنان إجتاز إختبارات صعبة ونجا منها، ما يوحي بأنه سيصبح ثابتا.
كما أن السفيرة الأميركية والتي ستزور الرئيس نبيه بري مع سفراء الخماسية وبطلب منها، تتحضر بدورها لمغادرة لبنان باكرا لتمضية إجازة الأعياد الطويلة.
ولا يبدو أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من الشهر المقبل ستؤدي الى نتيجة، كون الطرفين الأميركي والإيراني يريدان تأجيلها. فواشنطن تريد انتظار تثبيت الوقائع الميدانية الجديدة في المنطقة ما يجعل حل “أحجية” الرئاسة وإعادة إطلاق عجلة الدولة أسهل وأوضح. وطهران من جانبها تراها تريد تجميع أوراق قوة بيدها بعد احتراق الكثير من أوراقها خلال العام المنصرم. وبهذا تكون الرئاسة اللبنانية وفك أسر الدولة ورقة قوية بيدها لطرحها على طاولة المفاوضات والتي من المفترض أن يحين أوانها بعد دخول دونالد ترامب الى البيت الأبيض ومعالجة ملف نفوذ إيران في العراق. ومع الإشارة هنا الى تلويح ترامب بضرورة إغلاق ملف الأسرى في غزة قبل دخوله البيت الأبيض وذلك لعدم تركه ورقة تفاوضية بيد طهران.
وخلال الأيام الماضية نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالة لافتة لا بل مثيرة لنائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف وحظيت بإهتمام الدوائر الأميركية المختصة. وكرر ظريف فيها وجوب انفتاح طهران على الحوار مع العواصم الغربية وفي طليعتها واشنطن، ولو على أساس “التفاوض المتكافىء” حول الملف النووي. لكن ظريف استفاض بشرحه حول أهمية التكامل الإقتصادي بين دول المنطقة، ومشيرا على الدوام بأن بلاده تسعى دائما للسلام مع ثقتها بقدراتها الدفاعية.
وأهمية ما كتبه ظريف ليس فقط بمضمونه بل خصوصا بتوقيته، خصوصا وأن ترامب تحدث دائما عن قناعته بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط ومعالجة الملف الإيراني في بداية ولايته الثانية.
هو زمن التسويات والذي لم يعد بعيدا.